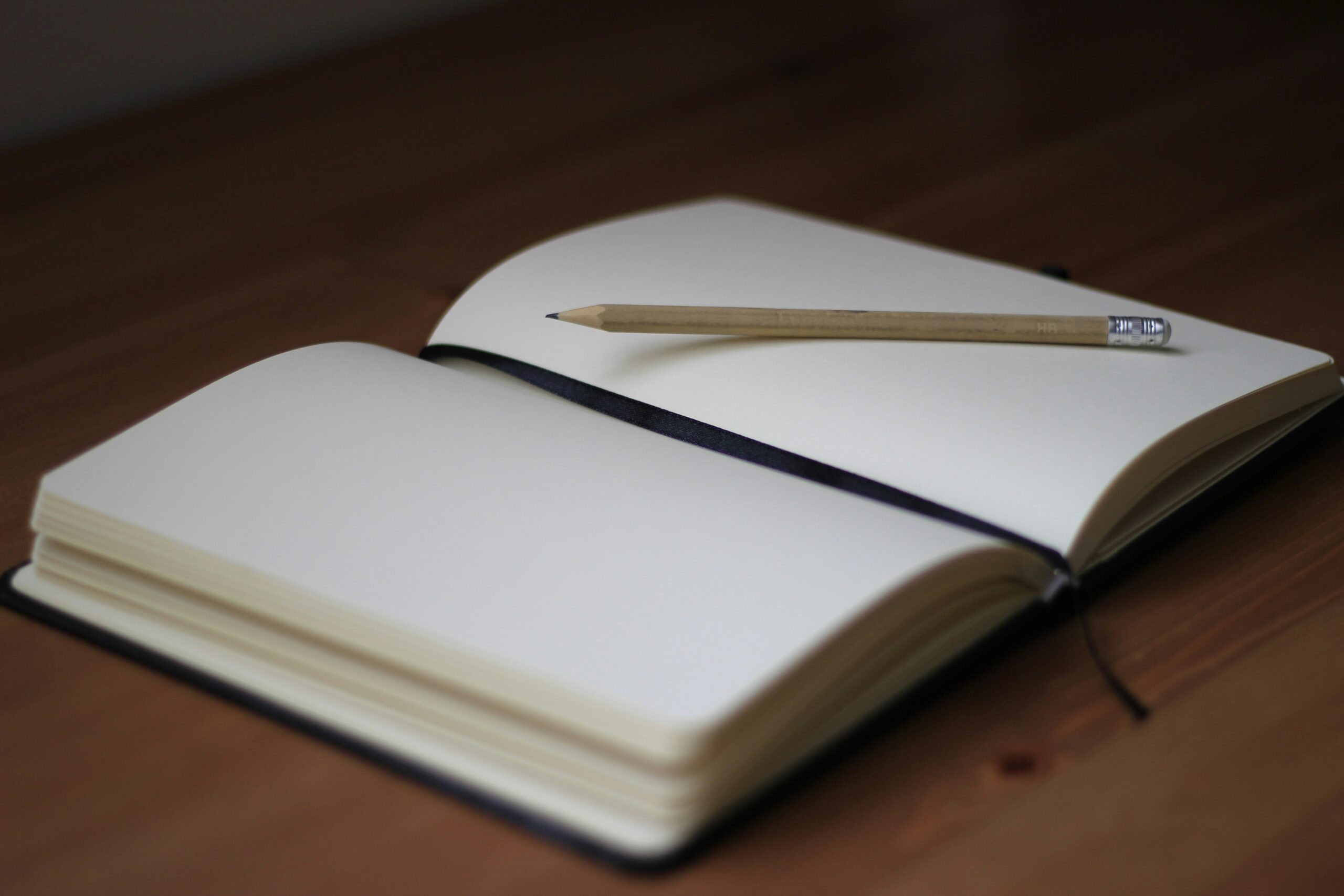لطالما كان الإلحاد يُنظر إليه على أنه نقيض الدين، حيث يقوم برفض الإيمان بإله أو قوى خارقة. لكن في العقود الأخيرة، بدأ البعض يطرح تساؤلات حول طبيعة الإلحاد ذاته: هل هو مجرد غياب للإيمان، أم أنه أصبح شكلاً من العقيدة الأيديولوجية التي تتبنى رؤى شمولية للعالم، تمامًا مثل الأديان التي يعارضها؟
في ظل هذا الجدل، يظهر سؤال أعمق: هل يمكن أن يتحول الإلحاد إلى منظومة فكرية مغلقة، ذات مبادئ صارمة، ورموز فكرية، وأتباع متحمسين، بحيث يصبح أقرب إلى الدين منه إلى مجرد موقف فلسفي؟
الإلحاد الكلاسيكي مقابل الإلحاد “النشط”
تقليديًا، كان الإلحاد موقفًا فرديًا يعبر عن عدم الإيمان بوجود إله، دون أن يكون له بالضرورة بُعد اجتماعي أو تنظيمي. لكن في العصر الحديث، ومع انتشار ما يُعرف بـ”الإلحاد الجديد”، ظهر نوع مختلف من الإلحاد يتميز بخصائص أقرب إلى الحركات الدينية.
الإلحاد الجديد، الذي برز مع مفكرين مثل ريتشارد دوكينز وسام هاريس، لا يكتفي فقط برفض الإيمان، بل يسعى إلى مهاجمته علنًا، ويعمل على نشر فكر الإلحاد باعتباره “الحقيقة العلمية الوحيدة”، مما يجعله أقرب إلى حركة فكرية منظمة بدلاً من مجرد موقف فردي.
يقول نادر الأسعد، الباحث في علم الاجتماع الديني، إن “هناك فرقًا بين الإلحاد كخيار شخصي، والإلحاد كإيديولوجيا. حين يتحول الإلحاد إلى موقف شمولي يُصنّف المتدينين على أنهم جهلة أو متخلفون، فهو يصبح أشبه بعقيدة مضادة، لها أتباعها ونظامها الفكري الخاص”.
إحدى الحجج التي يستخدمها البعض للقول إن الإلحاد قد يتحول إلى شكل من أشكال “الدين” هو أن بعض التيارات الإلحادية الحديثة بدأت تطور نوعًا من الطقوس والرموز الفكرية التي تعزز هويتها الجماعية.
على سبيل المثال، هناك مؤتمرات سنوية للإلحاد، يُلقى فيها خطب تحفيزية عن “تحرر العقل”، وتُنظم لقاءات تجمع الملحدين تحت هويات فكرية موحدة. كما أن بعض الحركات الإلحادية بدأت في تبني رموز معينة، مثل حرف A الأحمر الذي يرمز إلى الإلحاد، والذي يتم وضعه على الملابس والشعارات تمامًا كما تُستخدم الرموز الدينية في التعبير عن الهوية.
يقول جلال المنصور، الباحث في تاريخ الأديان، إن “الطقوس ليست بالضرورة مرتبطة بالدين، لكنها أداة لتعزيز الهوية الجماعية. حين نرى مجموعات إلحادية تحتفل بيوم عالمي للإلحاد، أو تطور شعاراتها الخاصة، فهذا يشير إلى أن الإلحاد يتحول من كونه مجرد موقف فكري إلى ظاهرة اجتماعية لها أبعاد رمزية”.
في الأديان التقليدية، يتم الاعتماد على النصوص المقدسة كمصدر للحقيقة. أما في التيارات الإلحادية الحديثة، فيتم التعامل مع العلم بنفس الطريقة تقريبًا، حيث يُنظر إليه على أنه المصدر الوحيد للحقيقة، وأي محاولة لمناقشة جوانب غير مفسرة علميًا يتم رفضها باعتبارها “غير عقلانية”.
لكن المشكلة تكمن في أن العلم، رغم قوته التفسيرية، ليس معصومًا، وهو يتطور باستمرار، مما يجعل “التقديس” المطلق له إشكاليًا من الناحية الفلسفية.
يقول هيثم مراد، الباحث في فلسفة العلوم، إن “العلم أداة لفهم العالم، لكنه لا يجيب على جميع الأسئلة. حين يتحول الإلحاد إلى نوع من التقديس للعلم، ويرفض أي نقاش حول جوانب غير مفسرة، فهو يصبح شبيهًا بعقيدة إيمانية، حيث يتم تبني بعض الأفكار كحقائق مطلقة، دون القبول بإمكانية تغيرها”.
التبشير بالإلحاد: هل يمكن أن يصبح “دينًا تبشيريًا”؟
إحدى السمات التي تميز الأديان عن المواقف الفلسفية الأخرى هي الرغبة في نشر الإيمان وإقناع الآخرين به. ورغم أن الإلحاد كان تاريخيًا خيارًا شخصيًا، إلا أن بعض الحركات الإلحادية الحديثة بدأت في اتباع نهج تبشيري واضح، حيث يتم تنظيم حملات إعلامية لإقناع المتدينين بالتخلي عن معتقداتهم، وأحيانًا يتم استخدام لغة مشابهة للخطاب الديني، لكن بمدلول عكسي.
في بعض الدول، ظهرت حملات على الحافلات والشوارع بشعارات مثل “الله غير موجود، استمتع بحياتك”، وهي حملات تهدف إلى نشر الإلحاد بنفس طريقة التبشير الديني.
يقول رغيد المصري، الباحث في علم النفس الاجتماعي، إن “حين يتحول الإلحاد إلى حركة منظمة تستهدف جذب المزيد من الأتباع، فإنه يصبح مشابهًا للديانات التي تحاول نشر معتقداتها. المشكلة ليست في نشر الأفكار، بل في الطريقة التي يتم فيها تصوير الإلحاد كحقيقة نهائية، مما يحوله إلى منظومة فكرية منغلقة، بدلاً من كونه مجرد موقف نقدي تجاه الأديان”.
الإلحاد، في جوهره، هو رفض الإيمان بوجود إله، لكنه في بعض مظاهره الحديثة بدأ يأخذ شكل حركة فكرية شمولية تمتلك خطابًا تعبويًا، ورموزًا، وطقوسًا، وأحيانًا حتى توجهًا تبشيريًا.
ربما لا يمكن اعتبار الإلحاد دينًا بالمعنى التقليدي، لكنه بالتأكيد لم يعد مجرد “غياب للإيمان”، بل تحول في بعض الحالات إلى نظام فكري بديل يسعى إلى فرض رؤيته للعالم بنفس الحماسة التي تسعى بها الأديان التقليدية إلى نشر معتقداتها.
السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الإلحاد دينًا أم لا، بل ما إذا كان يمكن للإنسان أن يتبنى موقفًا نقديًا تجاه الأديان، دون أن يقع في فخ بناء عقيدة مغلقة خاصة به، تحل محل الأديان التي يعارضها.